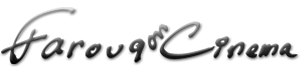“جسور مقاطعة ماديسون”
Bridges of Madison County
2002
أعزائي المشاهدين مساء الخير…
قد لا يوجد تشابه كبير، أو صغير، بين كثير من السينمات القومية في العالم اليوم…أعني تشابهًا في الظروف الإنتاجية أو حتى في المزاج العام. ولكن هناك “مشكلة” واحدة يمكن القول بأنها نجحت في أن توحّد بين سينمات العالم، صغيرها وكبيرها خاصة وهي مشكلة يبدو أن أحدًا لم يصنعها، بل هي في الواقع من صنع الزمن وما يعرف “بسنن الأشياء”. فالنجوم والممثلون تتقدم بهم الأيام والأعوام، ككل البشر، من ربيع العمر إلى منتصف العمر إلى ما بعد منتصف العمر.
ولأن السينما فن يُصنع منذ نحو مائة عام بهدف التسويق التجاري، فإن منتجي الأفلام ومن ورائهم جيوش الكتاب والفنانين ومؤسسات الدعاية، يصنعون الأفلام لتلبي احتياجات النسبة العظمى من مستهلكى السينما اليوم أي مرتادي دور العرض بالدرجة الأولى عبر شاشات العالم .
من يكون هؤلاء المستهلكون؟
السواد الأعظم منهم مراهقون وشباب تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والست وعشرين عامًا. وطبقا لإحصائيات حديثة لمؤسسة بول كيجان الأميركية فإن حجم شباك التذاكر العالمي اليوم وصل إلى نحو خمسة وعشرين بليون دولار تشكل الدولارات الشابة فيه نحو 72%.
نسبة هائلة لكنها واقعية!
لذا تصنع غالبية الأفلام في كل مكان، لتلائم أذواق تلك الشريحة “العظمى” المستهلكة، والمسئولة بالتالي عن تدوير أموال الصناعات السينمائية في العالم على أسس اقتصادية واضحة…عرض وطلب…تمويل وإنتاج وتوزيع، ثم تمويل وإنتاج وتوزيع…وهكذا.
في هذا الضوء من يهتم من جمهور المستهلكين الأعظم هذا، بالذهاب إلى دار عرض لشراء تذكرة دخول لمشاهدة قصة يقوم بتمثيلها فريق من الممثلين تمتد أعمارهم من الخمسينات إلى السبعينات؟
لهذا ظهرت ” المشكلة ” التي تعم حدتها سينمات العالم القومية بلا استثناء!
فكتاب القصص والسيناريوهات لا يكتبون أعمالهم، إلّا فيما ندر، لتروي حكايات هؤلاء العجائز. الذين لا تسعى إليهم الشريحة الشابة العظمى المستهلكة للسينما، وبالتالي لا تتحمس شركات الإنتاج للمخاطرة بتمويل إنتاج تلك القصص القليلة المناسبة لهؤلاء الفنانين الكبار (!).
فاصل (1) البرنامج
لهذا عندما نشرت رواية قصيرة لكاتب اسمه روبرت جيمس والر في مطلع عام 1993، سارع الممثل المنتج المخرج كلينت إيستوود إلى شراء حقوق تمويلها إلى فيلم على الفور!
فهناك جوع حقيقي دولي إلى أدوار مناسبة للفئات العمرية من الممثلين كبار السن!
ولكن…كما أن هناك ” حقائق ” يفرضها السوق السنمائي في كل مكان، فهناك أيضا “عجائب” قابلة للحدوث.
فما إن نشرت تلك الرواية القصيرة التي تقع في 171 صفحة، وتدور حكايتها حول علاقة عاطفية بين رجل وامرأة في منتصف العمر، حتى تصدرت على نحو غير مسبوق قوائم أفضل الكتب مبيعًا في أنحاء القارة الأميركية الشمالية.
السبب، قبل بلاغة التعبير الأدبي، يكفي تلمسه في “الصدق”…صدق المؤلف في التعبير عن موضوعه وشخوصه، وهو ابن نفس المنطقة الريفية في آيوا – الأميريكية. وهو يروي لنا حكايات مفعمة بتفاصيل صغيرة عن عالم يعرفه جيدًا، وهو ” صدق ” يمكن تلمسه أيضًا في تناول كاتب السيناريو ريتشارد لاجرافينيز لرواية والر “جسور مقاطعة ماديسون” وهو يدفع بشخصية المرأة الأربعينية الريفية السيدة جونسون إلى أوسع المساحات في المعالجة السينمائية لأنها ببساطة الشخصية السينمائية التي تحمل الدراما الفيلمية بكاملها تقريبًا على كتفيها!
ولكن من سيعنيه من جمهور الشريحة المستهلكة العظمى، مشاهدة كلينت إيستوود بعيدًا عن سهول “الكاوبوي” برصاصها المتطاير وعلامات “الشرطي” بقذائفها المتلاحقة؟
إنه هنا باختصار رجل خارج زمنه!
وإذا كان معيار “المال” مناسبًا لقياس حجم من كان يعنيه الأمر، تأتي “العجائب” في” صحبة الحقائق “!
فقد تكلف إنتاج الفيلم في عام 1995 – 22 مليون دولار وفي خلال أقل من عام كان قد بلغ دخل العروض السينمائية وحدها 176 مليون دولار! وحقق في العام التالي حفنة من الجوائز والترشيحات في مقدمتها أوسكار أحسن ممثلة لميريل ستريب، ولا أملك دراسة الآن تحدد الشرائح العمرية التي شاهدته، ولكن لابد أن قسمًا من شريحة الشباب قد شاهده، ولو على سبيل الفضول…
استمتع به أم لم يستمتع فتلك قضية أخرى!
فاصل (2) من الفيلم (إيستوود وستريب)
عندما قرر إيستوود إنتاج الفيلم بالمشاركة مع ستيفن سبيلبرج، قرر إخراجه أيضًا. لم يكن يطمع في البداية في تمثيل دور روبرت كينكيد. صحيح أن إيستوود، وعلى نحو مثير ومغاير لكثير من ممثلي جيله، قد استطاع أن يفر وبنجاح مدهش من “القالب” أو “النمط” الذي اشتهر به في أفلام الكاوبوي – الرجل الذي لا يحمل اسما، أو في أفلام الإثارة البوليسية – هاري القذر!
ولم يكن “الفرار” ميسورًا، ولكن إيستوود استطاع، خاصة خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، من أن يتحول تدريجيًا إلى طاقة إبداعية يحسب حسابها وتأثيرها في هوليوود كممثل ومخرج معًا.
ولكني أعتقد أن حماسته لتمثيل دور روبرت في فيلم الليلة، لم تتأكد إلّا بعد أن تيقن من حدوث أمرين:
الأول هو تكبير حجم دور فرانشيسكا جونسون في المعالجة السينمائية بما يسمح لها بالبروز في المقدمة.
والثاني هو قبول واحدة من أعظم ممثلات هذا العصر القيام بدور المرأة الريفية – السيدة جونسون.
الممثلة ميريل ستريب فيما يمكن أن يعرف بجاذبية الجمع بين النقيضين؛ إيستوود وميريل ستريب التي تتمتع هنا بسيادة مطلقة داخل منطقتها الأثيرة؛ التعبير عن امرأة في حالة صراع، وهي منطقة برعت فيها ستريب بما تحشده دائمًا من تقنيات تمثيل وفق مدرسة “المنهج”، ومن أدوات للتقمص في مقدمتها تطويع الجسد بزيادة الوزن أو نقصانه وبعشرات الإيحاءات والإيماءات الصغيرة من طريقة جلوس أو سير ربة البيت الفلاحة، إلى التعبير عن الفرح أو التوتر وغير ذلك مما يشكل في النهاية فسيفساء التعبير الحركي للمثل بما في ذلك إتقان لكنة الحديث لتكون إيطالية في “جسور مقاطعة ماديسون” مع مسحة من سلوكيات الممثلة الإيطالية آنا مانياني على الشاشة، وبولندية في دورها الفائز بالأوسكار في فيلم “اختيار صوفي” ولهذا نصدقها دائمًا!
فاصل (3) من “إختيار صوفي”
صوفي…فرانشيسكا…هذه هي نوعية الأدوار التي تبدع فيها ميريل ستريب منذ تميزت في “كريمر ضد كريمر” أي في عام 1979. أدوار تمثل المجال الحيوي لممثلة محترفة ذات أسلوب مدروس مناقض تمامًا لمدى المجال الحيوي لممثل فطري غير دارس ككلينت إيستوود كان يكتفي عادة في أفلامه الشهيرة الأولى بمجرد الظهور وتوجيه النظر. في فيلم الليلة هو واع بإمكانياته التمثيلية المحدودة وسعيه بإفساح المجال أمام ستريب لتبدع كما عودت مشاهديها.
ولكن إيستوود المخرج سيمتعنا بهدوء إيقاع حركته والبطء والتأني المحسوب في تقديم شخصياته وعرض الحكاية.
سيمتعنا ببناء فيلمه على شكل حكاية تروى بأسلوب الاسترجاع ” الفلاش باك” ومن ثم فنحن نعلم الخاتمة منذ البداية، ولهذا نركز كل اهتمامنا على التفاصيل التي أدت إلى هذه الخاتمة بعد تجربة حافلة في أربعة أيام من صيف عام 1965. كما أن هذا الأسلوب يعطينا متنفسًا من حين لآخر لتأمل الأحداث وربما التعليق عليها. وهي تتوهج بجاذبية ستريب وإيستوود في تفاعل كيميائي فريد بينهما…وهما اللذان لا نمل من متابعة حكايتهما التي تدور في معظم المشاهد في مكان واحد تقريبًا. وهي سمة نراها في الأفلام الأوروبية ومن النادر أن نراها في أفلام هوليوود حيث يتطور الحدث ليس بما يقال بقدر تأملنا ما لم يقال، وحيث تتحرك الكاميرا لترينا ما هو صامت لا لتروي لنا ما هو منطوق.
بعبارة أخرى فإن كل عبارة تنطق بها الشخصيات، خاصة فرانشيسكا وروبرت، تشع بالكثير في محيط صامت من الحركات والإيماءات التمثيلية التي تجعل من هذا العمل رواية ذكية لحكاية غير عادية في جو إبداعي درامي سينمائي متكامل . فيلم تنبع قوته من هدوئه ومن الكيفية التي ارتقت بها الحكاية من المستوى المادي إلى الأفق الروحي.
وقتا ممتعا في صحبة ستريب وإيستوود وفريق فني ممتاز ولنا لقاء بعد الفيلم إن شاء الله.
شكرا لكم…
الفيلم
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين…
لست أدري عنكم ولكني مأخوذ! ومن المحتمل أن أظل أعلق لساعات على أداء ستريب المذهل بتفاصيله الدقيقة أو على التصوير الرائع لجاك جريف أو على موسيقى ليني نيهاوس الراقية أو المونتاج المحكم أو قيم الإنتاج العالية، ولكن الوقت المتوفر قد لا يسمح بأكثر من التعليق المختصر على مشهد واحد يمثل قلب هذه الدراما!
أشار الناقد روجر إيبرت عن حق إلى “أن فيلم “جسور مقاطعة ماديسون” يروي حكاية شخصيتين تعثران على الوعد بتحقيق السعادة الذاتية الكاملة، ولكنهما تفهمان، بالقبول والحزن، أن أكثر الأشياء أهمية في هذه الحياة لا تتحقق بالضرورة في إسعاد ذاتك وحدها”.
ويعبر عن هذه الحقيقة ذلك المشهد الذي يمثل ذروة الدراما في الفيلم – لحظة الاختبار القاسي، الاختبار النهائي الحتمي بين ما هو صواب (البقاء مع عائلتها) وبين ما هو نداء صارخ قهري بإمكانية تحقيق الحلم…الوعد المؤجل.. المفقود بعد كل تلك الأعوام…
بحركة واحدة تفتح فرانشيسكا باب السيارة وحياتها الحاضرة…لتنطلق صوب وعد بحياة جديدة…ولكن المشهد يمثل أيضًا ذروة إبداعية سينمائية يكفي تدريسها أكاديميًا في منهج للإبداع السينمائي. فشريط الصوت قبل الصورة يحمل صوت المطر والضوضاء القليلة للمدينة إلى خلفية الشريط بينما تتقدم الموسيقى…تلك الموسيقى التي تتسلل لتسكن الفؤاد بالهمس لا بالصراخ لتلتحم مع صورة الحبيبين اللذين التقيا بلحظة اليقين التي “لا تأتي إلّا مرة واحدة في العمر”، وأرغما الآن على دفعها إلى مخزون الذكريات منذ هذه اللحظة…وإلى الأبد …
ولكن حتى هذا الحلم القصير…وهو يلفظ أنفاسه الحية الأخيرة ينتهي بالصوت المفاجئ لفتح باب السيارة الممتزج بضربة رعدية…
ويحمل شريط الصوت هنا آخر التعليقات الحية المباشرة لفرانشيسكا في الوقت الذي جاءت فيه تعليقات ريتشارد الزوج العفوية على سيارة روبرت وقائدها…لتؤكد رحيله عن العالم الآمن المستقر الذي يحياه ريتشارد مع فرانشيسكا.
وشاركت الطبيعة بقوة وحيوية في هذه الدراما بسيل المطر المنهمر وضربات الرعد التي ساهمت في تكوين إيقاع المشهد، ثم بتلك السحابات الرضية من بخار الماء التي أضفت مع الغمام لونًا أزرق باردًا بتنويعاته المختلفة…صقيع اليد الباردة القارسة التي تعتصر القلب لحظة الفقدان.
هذا هو كله ما يجعل من مشاهدة عمل ما متعة خالصة، لأنها نتاج مشاهدة سينما خالصة تتوسل بالصورة وبالصوت، بالإيقاع وبالأداء لكي تفي بوعد يتحقق يقطعه الفنان المبدع على نفسه، بإمتاع المشاهد المتأمل المتذوق إلى أبعد الحدود.
وهذا ما أتصور أن كلينت إيستوود المنتج والمخرج قد وفى به هنا.
بهذا أصل معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقة الليلة من “عيون السينما”…إلى أن نلتقي مساء الجمعة المقبل على خير إن شاء الله…أرجو لكم جميعًا أوقاتا طيبة ومفيدة وممتعة.
شكرا لكم وتصبحون على خير…